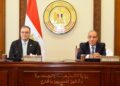بقلم – أحمد المريخي:
الحديث عن المصالحة هو حديث الساحة الآن؛ يحظى باهتمام إعلامى ومجتمعى ربما بطريقة يستغربها العامة؛ فمعظم المطروح مشوب بالالتباس؛ هل الأمر خاص بطرفى نزاع؛ (التيارات السياسية المدنية مقابل تيار الإسلام السياسى؟) أم الدولة مقابل الإرهابيين الذين يضربون هنا وهناك؟
فإن كان الأمر يتعلق بتيار سياسى تعترف به الدولة، فالمسألة تحتاج إلى حوار حقيقي، أما إذا كان متعلقًا بمن ارتكبوا ويرتكبون جرائم في حق المجتمع؛ فهذا ما لا يحتاج إلى حوارات وتضييع وقت.
وفي كل الأحوال فإن مناقشة مثل هذه الإشكاليات تحتاج قبلاً إلى إيضاحات ومعالجات إعلامية هادئة، لا تنتمى إلى صخب التطرف؛ إذ لم يعد فى الإمكان النظر إلى الإسلام السياسى الذى تنتهجه التيارات الدينية للمشاركة في السلطة (حكم البلاد) كمنهج يخدم الحضارة؛ فتلك التيارات من واقع التجارب انحرفت به عن مساره كأسلوب حكم مدنى، إلى الحاكمية (حكم إلهى)، وللأسف الشديد لم يقتصر توظيف الدين فى السياسة على التيارات الدينية وحسب، إنما معظم التيارات اللاعبة على الساحة السياسية؛ إذ تم توظيف الدين لأهداف برجماتية للاحتفاظ بالحكم أطول فترة ممكنة، وهو ما حدث فى عهد مبارك؛ إذ تعامل الحزب الوطنى مع التيارات الدينية كأصوات انتخابية.
ما هو أحق بالحوار قبل حديث المصالحة هو متى ولماذا حدثت المقاطعة وكيف تفشى الشقاق والانقسام فى المجتمع؟
وهو ما يردنا أولا للإشارة إلى ضرورة فهم أن الفتنة الكبرى بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان هى التى شقت صف المسلمين إلى فريقين سُنة وشيعة؛ وكانت بداية تغييب العقل ابتغاء رضاء الحكام.
ولأن هذه الحقيقة التاريخية أصبحت بديهة، فعلينا أن نتجاوزها إلى نقطة حوار رئيسية تتمثل فى بداية الشقاق في العصر الحديث؛ حيث كانت الإشكالية الأولى هي استقبالنا نحن العرب والمسلمين لـ«الحداثة»؛ ففهم الحداثة فى أوروبا يختلف عنه فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى أمريكا اللاتينية أو فى الشرق الأوسط؛ إذ نشأت الحداثة الأوروبية من أعمال ثورية قامت بها حركات اجتماعية برجوازية كانت تبحث عن السيطرة على مركز السلطة السياسية حتى يتسنى لها إعادة تشكيل المجتمع تبعا لليوتوبيات التى تتصورها، وكان استبدال التقاليد بالإيديولوجيات وإطلاق الأهداف الإيديولوجية من أهم بيانات الحداثة.
أما في أمريكا فقد نشأت مع نشأة الدولة، وفى أمريكا اللاتينية جاءت مع الانفصال عن أوروبا الكاثوليكية وارتبطت بالتحرر من الاستعمار الإسبانى، وفى معظم الدول الإسلامية جاءتنا الحداثة مع الاستعمار الأوروبى، وكما يقول هاينريش فيلهلم فى كتابه (صراع الأصوليات): «تبعًا لاختلاف عمليات تشكُّل الحداثات تختلف الأصوليات، وقد ارتبط الدين فى مصر والهند على وجه التحديد بماضٍ رجعى؛ حمل فى طياته خطرًا مستمرًا من الانقسام الطائفى؛ فعلى خلفية دخول الحداثة سعى بعض النشطاء الإسلاميين بعد العقد الأول من القرن العشرين، مثل البنا والمودودى ودى سافركار إلى تقنين التقاليد الدينية المختلفة والمتناقضة وتحويلها إلى أفكار ومبادئ أكثر تنظيمًا بهدف تكييف التقليد الدينى فى شكل حديث».
ووفق سكوت هيبارد فى كتابه (السياسة الدينية والدول العلمانية): «كان المحرك الرئيسى سياسيًا عن طريق إعادة تفسير التقليد الدينى، ووضع نموذج من التنظيم الاجتماعى له القدرة على تحدى الهيمنة الأوروبية داخل مجتمعاتهم، لكن بتفسيرات انتقائية وطائفية، وانجذبوا إلى المفاهيم الفاشية عن الأمة والأفضلية للجماعة على حساب الفرد، وتمكنوا من تبنى طائفية القومية العرقية ومعارضتها لمعايير وأعراف التنوير للمجتمع المنفتح»؛ مثلا الوطن الإسلامى عند حسن البنا يسمو عن الحدود الجغرافية والوطنية وعلاقات الدم إلى وطنية المبادئ الإسلامية.
ما أقصده من وراء ذلك الطرح هو أن «استقبالنا للحداثة وطريقة فهمنا لها» كان العامل الرئيسى فيما أصابنا من مصائب على رأسها عدم اعتماد التفكير العلمى فى كل أفعالنا، وعلينا قبل الحديث عن الإصلاح والمصالحة أن نجيب عن مجموعة من الأسئلة تتعلق بهويتنا كدولة؛ من نحن، وأى نظام نعتمد؛ وهل نحن حقًا دولة علمانية؟